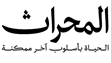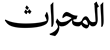Subtotal: $
Checkout
فحَيثُ يكونُ كَنزُكَ يكونُ قَلبُكَ يسوع الناصري
"ادخل"، قال الأستاذ الجامعي
فتح جون John الباب حيث كان جوتسروك Goatstroke يقرأ في مجلة علمية. فأومأ برأسه باتجاه الكرسي الخشبي الذي يقابل مكتبه. فجلس جون هناك صامتا، ينظر حوله في الغرفة، منتظرا من معلمه أن ينتهي من القراءة...
تنهد جون بألم وقال: "إنك تعرف زوجتي مرثا Martha – إنها حامل مرة ثانية".
أدار جوتسروك رأسه قليلا وقال:
"حسناً، أتوقع بأنك ستتولى أمر الموضوع بأسرع وقت ممكن. أليس كذلك؟"
فردَّ جون بصوت خافت: "إن مرثا تريد الطفل"...
"نعم، ولكن...". ثم وقف جوتسروك لكي يستجمع قواه، ثم قال: "أَصْغِ إلي، عليك أن تقنعها. إن لم يكن ذلك من اجل عملها، فمن أجل عملك... عليك أن تفهم... هذا عملك ومستقبلك يا جون. يجب أن تعيد ترتيب أولوياتك... فهذا ما يميّز الرجال عن الصبيان..."
في عالمنا الذي أصبح فيه المال يعكس ظله على جميع مظاهر الحياة العامة والخاصة، يكمن الخطر الأكبر على الأولاد في العدسات الاقتصادية التي ننظر من خلالها إليهم. فالنظر للأولاد كممتلكات أو استثمارات هو بحد ذاته عملية إجراء حسابات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يجري من كلام مثل الحديث الذي ذُكر أعلاه (من المذكرات الحديثة للكاتبة مارثا بيك Martha Beck حول الحمل بطفل في مجلة هارفارد Harvard)، يبدو واضحا أن العديد من الأشخاص الذين سيصبحون آباء وأمهات، ينظرون إلى الأولاد كموضوع غير مستحب وعلى أنهم: حمل ثقيل، على سبيل المثال، أو مخاطرة أو مسؤولية. ومن الواضح إننا نعيش في حضارة لا تفشل في دعم الأبناء في منعطفات وسقطات حياتهم المتكررة فحسب بل حتى تزدري بهم جهراً.
ومن السخرية، أن هذه النظرة المادية التي تشجع هذه العداوة نحو الأولاد، هي نفسها التي ترحب بهم بأيدي مفتوحة، عندما تكون عندهم نقوداً لينفقوها. وإذا كانت قوانين العمال قد أزالت الأولاد من القوة العاملة في العالم الغربي، فإن جيلنا الحالي لديه أسلوب مؤثر مماثل لأسلوب العبودية، ألا وهو: اكتشاف الطفل كمستهلك تجاري. وفي الوقت الذي يحاول فيه اصحاب الدعاية والاعلان النقر على جيوب الكبار المليئة الذين تعمل أموالهم على تشغيل أكثر المشاريع الاقتصادية ازدهارا في تاريخ العالم، فقد اكتشفوا أكثر الأسواق المريحة، ألا وهي: أولادهم الصغار من بنين وبنات. فإنّ أولادنا ومراهقي يومنا الحاضر، الذين يُعدون من أسهل الأهداف التجارية، وهم في الوقت نفسه من أكثر المتملقين اقناعاً لوالديهم، قد نجحوا في ترويض والديهم ومسكهم من اللجام وجرّهم إلى المجمعات التسويقية الكبيرة Mall أسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر، وعاما بعد عام.
وليست المدارس بحال أفضل، فمع تزايد عدد الاقاليم في البلد، تحاول المديريات التربوية اقناع مدراء المدارس على توقيع عقود مع شركات تجارية كبيرة مثل قناة واحد Channel One وبيبسي كولا Pepsi للحصول على تخفيضات في التكاليف عندما تصرف المديريات مخصصات مالية للمدارس لغرض شراء اللوازم المدرسية مثل حواسيب حديثة أو عُدَد رياضية أو آلات بيع الاطعمة الاوتوماتيكية، إلّا أنّ هذه الشركات التجارية تكسب بالمقابل من وراء هذه الصفقة حقّاً كاملاً لتسويق منتجاتها في المدارس إلى الجموع الطلابية الشغوفة أثناء أوقات الغداء والاستراحة.
ورغم أن الملايين من الأولاد حول العالم يعيشون في ظروف فقر مُدقِع، إلّا أنّ معظم الأولاد في الدول المتطورة مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لديهم أكثر مما يحتاجون إليه. فنحن نقوم بتربية جيل يمكن أن نطلق عليه جيل الأولاد المدللين. لكنه بالرغم من أنّ العديد من الوالدين يلقون باللوم على أسلوب الحياة الماديّ بصورة عامة - مثل الأطعمة التجارية المنتشرة والإعلانات التجارية، التي يتعرض لها الأولاد يومياً – إلَّا أنني أعتقد أنّ المشكلة لها جذور أخرى أيضا.
إن الأطفال المدللين هم نتاج الوالدين المدللين الذين يصرون على الاستمرار في أسلوب حياة يقوم على فكرة وهمية تقول أن إشباع الرغبات الحالية يجلب لهم السعادة. فالأطفال لم يفسدوا بسبب فائض الطعام والألعاب والملابس والأشياء المادية الأخرى فحسب بل حتى بسبب الآباء الذين كانوا يستجيبون لنزواتهم منذ أن كانوا في الحضانة. وهذا بحد ذاته أمر سيء للغاية، فعندما يكبر هؤلاء الأطفال، تصبح المشكلة أكثر سوءا. فكم عدد الأمهات اللواتي يبذلن أقصى ما في وسعهن وليس لديهن شغل شاغل غير تلبية طلبات أولادهن؟ وكم أكثر عدد النساء الأخريات اللواتي يوافقن على طلبات أولادهن مجرد لجعلهم يسكتون ويهدئون؟
وقد نشأتُ أنا شخصيّاً كواحد من أبناء المهاجرين الأوروبيين، الذين هربوا إلى أمريكا الجنوبية خلال الحرب العالمية الثانية، في بيئة لو نظرتُ إليها الآن لاعتبرتها فقيرة. وكنا في سنوات عديدة في بداية حياتنا، نحصل على اقل ما يمكن الحصول عليه: مثل عصيدة النشا مع دبس السكر أو الخبز المدهون بالشحم والمرشوش بالملح – وكانت هذه من الاطعمة التي كنا نعتبرها متميزة. ورغم كل ذلك، يصعب عليّ إيجاد حياة طفولية أحلى منها. أتتساءل عن السبب؟ لأن والداي صرفوا وقتاً كبيراً معنا نحن الأولاد فضلاً عن إبداء اهتمامهم بنا يومياً. وبغض النظر عن كثافة جدول أعمالهما، إلّا أنهما كانا يحاولان كل جهدهما لتناول وجبة الفطور معنا، على سبيل المثال، كلنا كأسرة قبل أن نذهب للمدرسة في كل صباح. وقد فعلا ذلك لما يزيد عن عقد كامل، حتى تمكنت أختي الصغيرة (وكنا سبعة أفراد) من التخرج من المدرسة الثانوية.
إنّ فكرة تناول الأسرة كلها وجبة طعام في بداية اليوم (أو في نهايته)، تُعدّ اليوم شكلا من أشكال حياة الترف والرخاء من قبل معظم الناس. وحتى لو تاق الناس لذلك، فإن تضارب أوقات دوام العمل وطول فترات المواصلات تجعل ذلك مستحيلا. ولكن مهما كان السبب، فان الأولاد هم الخاسرون. وأنا لا أقتنع بأن الأمر يرتبط دائما بالحالة الاقتصادية، فغالبا ما يكون ذلك التنوع في فوضى الذهاب والإياب في حياة أفراد الأسرة في العديد من البيوت، نتيجة الإصرار على المحافظة على مستوى معيشي مُرَفَّه.
من الواضح انه لا يمكن العيش بدون المال والحاجات المادية، وكل بيت يحتاج إلى معيل له، وإلى تخطيط مستقبلي. وفي نهاية الأمر إن الحب الذي نعطيه لأولادنا، وليست الأشياء المادية، هو الشيء الذي سيبقى معهم طوال حياتهم. وهذا شيء ننساه جميعنا بسهولة، عندما يُغرينا راتب أكبر، أو عمل أفضل، أو فرصة من اجل جني ريال إضافي. وقد كتبتْ لي صديقة لنا، بات Pat قبل فترة قصيرة عن طفولتها التي كانت قد قضتها بصحبة والدها، الذي كان يتنقل من فرصة عمل إلى أخرى، فقالت:
مثل معظم الرجال من هذا الجيل، اختار أبي أن ينغمس في عمله، وكان ضابطا في القوة الجوية. واستطيع أن أتذكر جيدا المناسبات التي كان يخصص الوقت فيها للبقاء معنا، وكانت كل منها متميزة جدا، لأنها كانت قليلة. كنا نحب والدنا كثيرا جدا، فقد كان شديد اللطف والعناية بنا عندما يكون في البيت. لم نشعر بأنه أهملنا في تلك الأوقات؛ فكان طبيعيا أن يعمل في كل نهاية أسبوع، أو أن يكون بعيدا عن البيت لمدة شهر أو سنة في بعض الأوقات. وأتساءل الآن بعد أن أصبحتُ بالغة: لماذا ضحى والدي بكل ذاك الوقت؟ هل من أجل المهنة؟ أو، من أجل بلاده؟ بالتأكيد ليس من أجل المال. وتدهشني الكيفية التي تتقنّع بها الأنانية عندما تتستّر بصيغة "أداء الواجب". ورغم ذلك، فأنا متأكدة لو أن زواجي قد استمر، ولو كان لدي أولاد، لكنا قد فعلنا الشيء ذاته تماماً. لأن وضع المهنة في قائمة الأولويات يُعتبر مسألة طبيعية لدى الأُسر من الطبقات الميسورة والعليا...
واني أرى العديد من الآباء والأمهات من أبناء الطبقة المُرفَّهة، يغرقون في مجال عملهم، ويعملون من أربعين إلى ستين ساعة في الأسبوع، كطريقة سهلة من اجل الحصول على قناعة فورية بدلاً من قضاء الوقت مع أولادهم. ويبدو أن الأمر أكثر سهولة في أن تصبح جزءا من نظام يحدد قواعداً وأهدافاً، وان تنجح في جو من التعاون، بدلا من قضاء الوقت في البيت لترتيب الأمور هناك.
وتكون الحجة دائماً: "أنا اعمل لأجل أن أتمكن من توفير التعليم لأولادي في الجامعة،" أو "أود أن أسدد دفوعات رهن الدار لكي أتمكن من ترك شيء ما لأولادي." والحقيقة التي لا جدال فيها هي: أنّ تكريس حياتك لخدمة أولادك وقضاء وقتاً معهم هو أصعب بكثير من أن تشتغل "لأجلهم"، ومن تجميع المال "للمستقبل" – فإنك تريد شراء محبة لأولادك. إلّا أنهم لا يريدون ميراثا، وإنما يريدونك أنت فقط، ويريدونك الآن.
وتريد "بات" أن تشير إلى أن الأولاد لا يرون الفوائد المادية بنفس الطريقة التي يراها البالغون. ولكي أعود إلى بعض ذكريات طفولتي في أمريكا الجنوبية، فاني اذكر جيدا أحد الزائرين من أمريكا الشمالية، الذي شعر بالغضب عليّ وعلى أختي، وسألنا: أليست الحياة صعبة بهذا المستوى المعيشي المتدني؟ فنظرتُ إلى ذاك الرجل الغريب وتساءلتُ بيني وبين نفسي: صعبة؟ ماذا يعني هو بذلك بحق السماء؟ لأنني كنت على يقين من أنني كنت أعيش في الفردوس. ويسهل علي الآن كرجل بالغ أن افهم وجهة نظره، وخاصة بعد أن قمت بتربية أولادي في بلاد الثروة الغنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه، لا استطيع أن أنسى انه قبل خمسين عاما، رأيت الموضوع من زاوية مختلفة، فقد رأيته على أنه إشارة تدل على ضعف التفكير.
وللحديث عن الاختلاف في وجهات النظر، فلقد شعرت بالدهشة خلال سفري حول العالم، عندما وجدت أن بعض الأماكن الأكثر فقرا في العالم، يوجد فيها عطف كبير على الأولاد، رغم أنه لا يوجد فيها أي من الفوائد المادية التي نجدها بشكل أكيد في المناطق المتطورة في الغرب. إن نسبة موت الأطفال هناك عالية، والطعام قليل، والدواء غير متوفر دائما، هذا إذا كان هناك دواء أصلاً. وتتألف ألعاب الأولاد عندهم من العيدان أو علب الصفيح، وتصنع الثياب من الأسمال البالية أو القمصان القديمة. ولا يوجد لدى الأطفال الرضع زجاجات للرضاعة أو أسرّة للنوم أو عربات أطفال. ورغم ذلك لم أر في مكان آخر مثل تلك الابتسامات المشرقة، أو العناق الحار من القلب. ولم أر في أي مكان آخر عطفا أعظم بين الآباء والأمهات والشباب، بين كبار السن والأطفال الصغار، سوى في هذه الأماكن.
ماذا ينقص بيوتنا المترفة جداً وصفوف مدارسنا الفارهة في بلادنا بحيث يصبح أولادنا بهذه الحالة المزرية، بالرغم من توافر كل المستلزمات الدراسية التي يحتاجونها؟ ربما يرجع السبب حسبما يقول طبيب الأطفال النفسي روبرت كولز Robert Coles إلى عدم وجود قضية نعيش ونعمل من أجلها، غير السيارة الأحسن والبيت الأكبر. فيقول:
إني اعتقد أن ما يحتاج إليه الأولاد بشدة هو وجود هدف معنوي. والعديد من أولادنا هنا لا يتوفر لديهم ذلك، وإنما يوجد لديهم آباء وأمهات يهتمون كثيرا بإرسالهم إلى أحسن الجامعات، وشراء أحسن الملابس لهم، وتوفير الفرصة لهم لكي يعيشوا في حي يمكن أن تكون فيه حياتهم مستقرة وجيدة، وحيث يمكن أن يحصلوا على أفضل الأشياء، والذهاب في عطل مثيرة، وغير ذلك من الأشياء الأخرى...
أنا لا أدعو إلى الفقر، ولست متعاميا عن حقيقة وجود العديد من الأطفال الفقراء في "العالم المتقدم"، من مزارع كاليفورنيا وواشنطن إلى أحياء فقيرة في روما وايست اند East End في لندن. ففي هذه الأماكن وغيرها التي يصعب ذكرها لكثرتها، يُحرم الأولاد من اغلب الحاجات الضرورية الأساسية، هذا إذا تركنا جانبا الأمور الأخرى الجميلة التي يشعر معظمنا بأننا نستحقها. رغم ذلك فاني اعتقد اعتقادا جازما بأن سعادة الولد في نهاية الأمر، لا تعتمد على امتلاكه للثروة المادية، وان أي شخص يتشبث بمثل هذه العقلية القصيرة النظر، يكون قد وقع تحت تأثير وهم جاهل بل حتى خطير.
قالت الأم تريزا مرة بعد زيارة إلى أمريكا الشمالية، إنها لم تر قط مثل هذه الوفرة من الأشياء، ولكنها أضافت قائلة: "أنني لم أرَ أيضا مثل هذا الفقر الروحي والوحدة والشعور بالرفض لدى الأولاد... وإن أسوأ مرض في العالم اليوم، ليس السل أو الجذام... انه الفقر الذي ولد نتيجة نقص المحبة."
ماذا يعني أن تقدم المحبة للولد؟ إن العديد من الوالدين وخاصة الذين يبعدهم عملهم عن عائلاتهم لأيام أو أسابيع في بعض الأحيان، يحاولون التغلب على الشعور بالذنب من خلال إحضار الهدايا للبيت. وينسى هؤلاء رغم نيتهم الحسنة، أن ما يريده أطفالهم حقا ويحتاجون إليه، هو العناية وقضاء الوقت معهم، وآذان صاغية وكلمات تشجيع. ولسوء الحظ نادرا ما يحصل العديد من الأولاد على مثل هذه الأشياء.
وعندما عملت "جينا Gina" - وهي صديقة لإحدى بناتي - معلمة في حضانة في إحدى المدارس النهارية الخاصة في جورجيا، أعجبتْ بها في بداية الأمر. فقد كانت المدرسة صغيرة ومنظمة، وتحتوي على أثاث جيد، وعدد قليل من الأولاد في كل صف. ويأتي جميع هؤلاء الأولاد كما يبدو من عائلات راقية وهامة. ولم يمض وقت طويل حتى تحول حماس جينا إلى صدمة. فها هي تحكي لنا:
يملك آباء هؤلاء الأطفال الذين اعتني بهم، كل شيء يرغبون فيه: سيارات فخمة، وملابس ثمينة، وبيوت كبيرة، وما يكفي من النقود للإنفاق – ولكن العديد منهم إما مطلّق، أو يمارس الخيانة الزوجية، أو يتعاطى المخدرات والكحول، أو يتشاجر مع زوجته (أو زوجها) وبعضهم يؤذي بعض في البيت... ويمكن مشاهدة كل ذلك من خلال الأطفال.
فالطفلة الصغيرة "اماندا Amanda" التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، لا تفعل شيئا سوى أن تتصرف بمزاجية نتيجة نوبات الغضب التي امتلأت بها نتيجة للإحباط تجاه والديها. وغالبا ما تتلفظ بكلمات مثل: " أنا اكره أبي" أو "لن ادع أمي تأخذني اليوم معها".
والدي اماندا لا يعيشان معا، ولم يتزوجا أصلاً، ولكنهما تقاسما الوصاية عليها. وهذا يعني في حالتها، أن تقضي عددا من الأيام مع احد الوالدين، ثم تقضي بعد ذلك عددا مساويا مع الآخر وهكذا. وتتسم الأيام التي تتحول فيها من الأب إلى إلام وبالعكس بالفوضى، فهي تبلل فراشها في وقت النوم، وتعض. وتضرب. وتخدش الأطفال الآخرين، وتسبب الإزعاج في الصف في كل مرة تسنح لها الفرصة بذلك.
وقبل فترة وجيزة بدأت والدة اماندا بمصادقة رجل آخر، وطلبتْ من ابنتها اماندا أن تدعوه "بابا"، ولذلك أصبح لديها الآن أبوان، مما جعل الطفلة مضطربة بصورة كلية! وفوق كل هذا، تتوقع أمها منها أن تكون "فتاة طيبة"، وان يبدو مظهرها حسن في كل الأوقات. واعتدتُ أن أرتب شعرها عندما تأتي أمها لتأخذها في نهاية النهار.
وهناك طفل آخر وهو "جيراد Jared"، لا يشعر كثيراً بالأمان النفسي والاطمئنان، خاصة في وقت النوم. ويرغب في كل يوم أن اجلس بالقرب من فراشه، وان أقوم بفرك ظهره أو ملاطفة شعره والغناء له – وهذا ليس من اجل أن ينام، ولكن من اجل تهدئته قليلا فقط، ولكي يبقى مضطجعا.
وقد اشتغلت كمربية في بيت جيراد في بعض الأحيان. واستطيع أن أخبرك عن سبب تعاسته. فقد وجدت في أول ليلة وصلت فيها إلى البيت، في الوقت الذي كان فيه أبوه وأمه مسرعين، يجهزان أنفسهما من اجل الخروج للسهر خارج البيت الذي كانا يتقاسمانه. وكان الطفل "درو Drew" الذي يبلغ عشرة أشهر من عمره، يجلس وحيدا في كرسي مرتفع في المطبخ، مع زجاجة حليب فارغة وهو يصرخ، وكان جيراد الذي لم يبلغ الثالثة بعد، وحيدا في غرفة الجلوس يربض على الأريكة ويشاهد فلما من أفلام البالغين في التلفزيون. وبينما كنتُ واقفة عند المدخل، سارعت أم جيراد بإعطائي مجموعة من التعليمات عن وقت نوم الأطفال، قبل أن تنطلق إلى إحدى الحفلات مع زوجها الذي كان ينتظر في سيارته في الخارج...
بالتأكيد، أن إنجاب الأطفال شيء، وخلق بيتاً حقيقياً – أي بمعنى مكانا للحب والأمان - شيء آخر مختلف تماماً. ولسوء الحظ لا يدرك العديد من الكبار معنى ذلك. فهم "مشغولون" دائما، ولا وقت لديهم لقضائه مع أولادهم. وينشغل بعض الآباء انشغالاً كبيراً في أعمالهم أو في نشاطاتهم الترفيهية (كحالة الزوجين المذكورين أعلاه) لدرجة أنهم عندما يرون أولادهم في نهاية يوم طويل، لا يملكون ما يكفي من الطاقة ليكونوا معهم حقاً. فقد يجلسون في نفس الغرفة - وأحيانا على الأريكة نفسها – ولكن عقولهم ما زالت في العمل، وعيونهم على أخبار المساء.
ويعلم الآباء جيداً في أعماق نفوسهم، أن تربية الأولاد تستلزم أكثر من مجرد تزويدهم بما يحتاجون إليه من ماديات. هذا وقلما نرى أب أو أم لا يعترف بضرورة "قضاء المزيد من الوقت" مع أولاده. كما انه من النادر أيضا أن نجد أبوين لا يرغبان في الاعتراف بذلك بل حتى العمل على تحويل نواياهم الطيبة إلى أفعال حقيقية.
كان احد أصدقائي واسمه "ديل Dale" يعمل في واحدة من اكبر الشركات القانونية في العالم، وهو واحد من هؤلاء الآباء ذوي النوايا الطيبة. ورغم أنه كان يكسب من المال في عام واحد أكثر مما يكسبه العديد من الناس في حياتهم، إلا أن راتبه ومركزه لم يعنيا شيئاً لعائلته - ربما لأنه لم يكن في المنزل لينعم بذلك معهم. وكان ما يقدمه من أعذار لا يجري قبوله قبولاً رحباً على الاطلاق - سواء كان ذلك من زوجته أو أولاده. ولهذا قرر "ديل" أن يستمع إليهم بدلاً من أن يقوم بالتمسك برأيه. وبعد أن سمع ما فيه الكفاية، قرر أن هناك شيئا واحدا يجب أن يقوم به: أن يترك الشركة. فها هو يقول:
قبل عشر سنوات، كنت عائدا مع أحد الزملاء من مسابقة لأشبال الكشافة في غابة من أشجار الصنوبر، وبينما كانت السيارة مليئة بالأولاد يلعبون ويضحكون في المقاعد الخلفية، تنحنح زميلي وبدأ يتحدث عن موضوع صعب. "ديل، لقد ارتكبتَ خطأ كبيرا بترك الشركة القانونية. هل تدرك ذلك؟" وكان يشير إلى قراري بتقديم رسالة إخطار بستة أشهر قبل استقالتي. ثم استمر في الحديث قائلا: "فلا يحقّ لك أن تفعل ما تريد، فلديك خمسة أطفال، ومن واجبك أن توفر لهم أحسن حياة ممكنة، وان ترسلهم إلى أحسن الجامعات التي يمكن أن يلتحقوا بها. انك تتهرب من واجبك".
ومرت لحظات قليلة، ثم أجبت عليه في النهاية قائلا: "لم تكن هذه الفكرة فكرتي، لم أكن انوي قط أن أُقلّص ساعات عملي إلى أقل من عشرين ساعة في الأسبوع، ولكن بناتي قمن بمناشدتي لكي اترك العمل".
وهذا ما حدث فعلاً، فقد نجحتُ خلال السنتين الماضيتين في جدولة عملي لكي لا أعمل أكثر من عشرين ساعة في الأسبوع في سلك المحاماة، بعدد مساو من الساعات لخدمة الرجال الذين هم على وشك الموت بسبب مرض الايدز أو السرطان. وكان هذا يعد تغييرا دراماتيكيا في حياتي كمحام قضى معظم وقته في الطائرات، وفتح الحسابات في كل أنحاء البلاد، وعمل لفترة ثمانين إلى تسعين ساعة في الأسبوع. ولكن عندما حدثت حرب الخليج، ازداد عملي الجزئي في المجال القانوني بصورة ضخمة ومفاجئة، وفي الحال وجدت نفسي أعود إلى جدولي القديم.
وبعد ستة أسابيع من هذه العودة، اختفت ابنتي التي كانت في الصف السادس من المدرسة: ذهبنا بعد ظهر احد الأيام لإحضارها، ولكنها لم تكن هناك. بحثنا عنها أكثر من ساعتين، ثم اتصلنا أخيرا بالشرطة. وقد وجدها فيما بعد أحد الأصدقاء وهي تسير وحدها على أحد أرصفة الطرق وهي تبكي. وكان تفسيرها بسيطا: "يا بابا، عندما كنتَ بعيداً عن البيت وتشتغل كل الوقت فلم أهتم، أما الآن لقد اعتدنا على وجودك هنا معنا، فلا أتحمّل أن تغيب مرة ثانية، أريد منك أن تترك عملك في سلك المحاماة".
حاولتُ في البداية أن اطلب من ابنتي التي كانت في الصف التاسع أن تتحدث إلى أختها الأصغر منها وتقول لها شيئاً معقولاً، ولكن ذلك لم يجد نفعا، فلقد اتفقت معها كليا. ثم وضعتُ الأمر على قطعة من الورق لكي تفكران فيه، ولكي اشرح لهما فقط كم ستكون العواقب الاقتصادية صعبة: فهناك دفع فواتير الملابس والسيارة والبنزين والتأمين والكتب المدرسية والحفلات الراقصة والكلية والرحلات الخ...، ولكنهما لم تُعِيرَا الموضوع أي اهتمام، فلم ترغبا في شيء سوى أن أكون معهما.
ومع اقترابنا من شارة الضوء الاحمر أخذ زميلي يوقف السيارة، وقال لي بضجر: "أرى أنك تتهرب من مسؤولياتك". ومرت لحظات قبل أن اختم حديثي، لأنني شعرت بأهمية إنهاء الحديث. وكنت في تلك اللحظة أصوب نظري نحو مجموعة من الأشجار التي كانت ترفض أن تكون في خط مستقيم، وترفض أن تخضع للسيطرة، وترفض أن يجري قطعها ثم قصّها بقوالب محددة في المصانع.
قلت له بلطف، لا أوافقك الرأي، لا أوافقك الرأي. وأنا أراهن انك في أعماق قلبك أنت أيضا لا توافق على هذا.